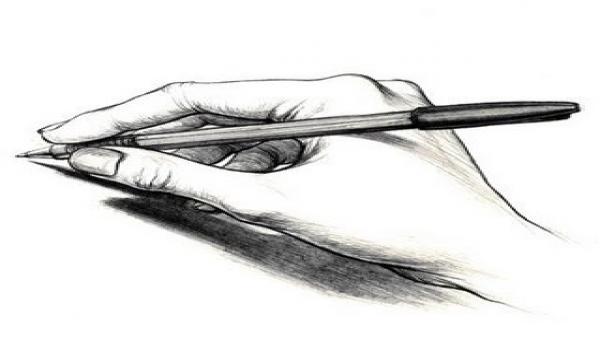
نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين. ويعدّ هذا العصر عصر انفجار المعلومات والتقنيات الحديثة التي لم يألفها أجدادنا. وكأن الأرض صارت كرةً صغيرةً في أيدينا، نقلبها متى ما نشاء وكيف نشاء. ورغم كل هذه التطورات الهائلة نحن لم نطوِّر أنفسنا على النحو المطلوب، من ناحية استخدام وتسخير هذه الوسائل لخدمتنا. فإذا تصفحنا أيَّ موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا هناك انتقادات نحو الآخرين. كأننا نحن المقربون فقط إلى ربنا. وغيرنا عصاة أو فجّار. وصرنا بعيدين عن السلوكيات والأخلاقيات التي علّمها الإسلام. كلنا مكلّفون بأن نحصل على أفضل ما لدى الآخرين من سلوكيات حسنة. ولم نفكر في أيّ حال من الأحوال كيف نحصل على أفضل ما لدى الآخرين بل نتطلع إلى عيوب وزلات إخوتنا. ونجيد لغة الانتقادات نحوهم. وقد سبق لي أن كتبت مقالاً بعنوان: (انتقد الآخرين لكن لا تنكر ميزاتهم). والشريعة الإسلامية وخاتمة الرسالات الإلهية، ترشدنا وتخبرنا، تصريحًا وتلميحًا، أن الخيرَ كلَّه في النصح والإرشاد والتوجيه، وليس في النقد والمعاتبة. وأمّا صفة النقد وحبّ النقد وشوق المعاتبة ورغبة إظهار عيوب الآخرين في كل صغيرة وكبيرة فهي صفة اللئام. وأمّا أصحاب النقد فما وجدوا في حياتهم الطمأنينة والراحة. وصاروا يفسدون ولا يصلحون. وفي الأخير كان مصيرهم مثلما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : (أدركت أقوامًا لم تكن لهم عيوب، فتكلّموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبًا وأدركت أقوامًا كانت لهم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم )
وأسطِّر هنا قصتين قرأتهما قبل مدة من الزمن. وربما كلّ قصّة تفيدني وتفيد كلَّ من يقرأ هذا المقال بعين الاعتبار والاتعاظ.
أما القصة الأولى : فكان هناك رسامٌ رسم لوحةً وظنّ أنها الأجمل على الإطلاق. وأراد أن يتحدّى بها الجميع فوضعها في مكان عام وكتب فوقها العبارة التالية : ( من رأى خللا ولو يسيرًا فليضع إشارةً فوقه ) عاد في المساء ليجدها مشوهة بإرشادات تدل على خلل هنا وهناك لدرجة أنّ اللوحة الأصلية قد طُمست تمامًا. ذهب إلى معلّمه وقرّر ترك الرسم لشدة سوئه. فأخبره المعلّم بأنه سيغير العبارة فقط. ورسم ذات اللوحة ووضعها بذات المكان ولكنّه وضع ألوانًا وريشة وكتب تحتها العبارة التالية : ( من رأى خللا فليمسك الريشة والقلم وليصلحه ) فلم يقترب أحدٌ من اللوحة حتى المساء وتركها أيامًا ولم يقترب منها أحد .... فقال له المعلم: كثيرون الذين يرون الخلل في كل شيء، ولكنَّ المصلحين نادرون، هذا هو حال الناس نرى ولا أحد يقدم الحلول.
وأما القصة الثانية: فيحكي أنّ حاكمًا في الصين وضع صخرة كبيرة على أحد الطرق الرئيسية فأغلقه تمامًا ووضع حارسًا ليراقب تلك الصخرة من خلف شجرة ويخبره بردة فعل الناس.
نعم، مرّ أول رجل وكان تاجرًا كبيرًا في البلدة. فنظر إلى الصخرة باشمئزاز، منتقدًا من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم. فدار هذا التاجر من حول الصخرة، رافعا صوته، قائلا : سوف أذهب لأشكو هذا الأمر، سوف نعاقب من وضعها.
ثم مرّ شخص آخر وكان يعمل في البناء، فقام بما فعله التاجر لكن صوته كان أقل علوًّا لأنه أقل شأنًا في البلاد من ذي قبل.
ثم مرّ ثلاثة أصدقاء معًا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هوايتهم في الحياة، وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم .. ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي ثم انصرفوا إلى بيوتهم.
مرّ يومان حتى جاء فلاحٌ عادي من الطبقة الفقيرة ورآها فلم يتكلم وسار إليها مشمّرا عن ساعديه، محاولاً دفعها، طالبًا المساعدة ممّن يمرّ فتشجّع الآخرون وساعدوه، فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق. وبعد أن أزاح الصخرة وجد صندوقًا تحتها. وفي الصندوق كانت ورقة فيها قطع من الذهب ورسالة مكتوب فيها:
«من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة. إن هذه مكافأة للإنسان الإيجابي المبارد لحل المشكلة بدلاً من الشكوى والنقد منها.
العبرة من هاتين القصتين: كم وكم نجد حولنا من الأشخاص السلبيين، وكم وكم من مشكلة نعانيها ليلَ نهارَ، صباحَ مساءَ، نستطيع حلَّها بكلّ سهولة، لو توقفنا عن النقد والشكوى. وأصلحنا عيوبنا قبل أن ننتقد الآخرين.. ونوجد لهم عشرات الحلول فلعل في أحدها يكون نجاحنا وتفوقنا. ونجرب فلن نخسر شيئًا. ولا ننسَ أنّ من راقبَ الناسَ -وانتقدَهم- مات همًّا.
محمد صومي كريم الرشادي

إضافة تعليق جديد